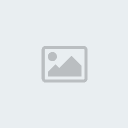التعيير بالذنب
ذنب أكبر
كتبه :ا.فتحى عبد الستار
يتفاوت
الناس فيما بينهم، غنى وفقرًا، سعادة وحزنًا، جمالاً وقبحًا، صحة ومرضًا،
ويتفاوتون أيضا من حيث طاعتهم لله عز وجل ومعصيتهم له سبحانه.
وكما لا تجيز الشريعة الإسلامية أن
يعيِّر واحدٌ من الخلق أخاه بنقص اعتراه في المجالات الدنيوية المختلفة،
أو يستطيل عليه بتفوقه في هذه المجالات، كذلك – بل من باب أولى – فإنها
تحرم أن يعيِّر المسلم أخاه بمعصية وقع فيها، ويتفاخر عليه بتقواه لله عز
وجل وطاعته له، فضلاً عن أن يفضحه أو يشهِّر به.
شماتة مرفوضة
إن التعيير بالذنب نوع من إظهار الشماتة بالمسلم، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ" (رواه الترمذي).
والمتأمل في هذا الحديث الشريف يجد
النهي الواضح عن إظهار الشماتة بالمسلم، والترهيب والتحذير لمن يفعل ذلك،
ومن أهم ما يدرَك من الحديث: التخويف من أن الشماتة أو التعيير قد يكونان
سببًا في ابتلاء المعير أو الشامت بالعيب أو النقص الذي عيَّر به أخاه.
إن الله عز وجل قد يعافي أخاك من
المعصية التي وقع فيها، وقد يغفر له تقصيره وذنبه، ويهيئ له سبل التوبة
والعودة والإنابة، ولكنك لا تدري إن ابتلاك الله عز وجل بمثل ما وقع فيه
أخوك...
هل ستعافَى أم لا؟
هل ستتوب أم لا؟
هل سيغفر لك الله ويقبل توبتك أم لا؟.
ومما روي من روائع الإمام ابن القيم
قوله:" إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثمًا وأشد ذنبا من المعصية ذاتها،
وذلك لأنه يحمل في طياته معاني التكبر والغرور بالطاعة لدى صاحبه، ويعبر
عن تزكية النفس وشكرها، ووصفها - ضمنيًّا- بالبراءة من الذنب، والتنزه عن
المعصية".
ويضيف ابن القيم: "ولعل كسر نفس أخيك
بسبب ما وقع فيه من ذنب، وما حدث له من الذلة والخضوع، بسبب ما اقترف من
معصية، وتخلصه من مرض الكِبر والعُجب، ووقوفه بين يدي الله منكس الرأس،
خاشع الطَّرْف، منكسر القلب، لعل هذا أنفع له وخير من صولة طاعتك وزهوك
بها، والمن بها على الله وعلى خَلقه".
ومما أثر من حكم ابن عطاء الله السكندري قوله: "رب معصية أورثت ذُلاً وانكسارًا، خير من طاعة أورثت عزًّا واستكبارًا".
وكلام ابن عطاء الله يتسق مع ما قاله
ابن القيم من أنه "ما أقرب المذنب العاصي من رحمة الله، وما أقرب المغرور
المتكبر من مقت الله!
إن الذنب الذي تَذِلُّ به لله عز وجل،
أحب إليه من طاعة تمُنُّ بها عليه سبحانه، فإنك إن تبيت نائمًا وتصبح
نادمًا، خير من أن تبيت قائمًا وتصبح معجبًا، فإن المعجب لا يصعد له عمل،
وإنك إن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت مُدِل، وأنين المذنبين أحب
إلى الله عز وجل من زَجَل المسَبِّحين المدِلِّين".
أيكون الذنب دواء؟!
ومن رحمة الله بنا أنه قد يجعل في الذنب
نذنبه دواءً لمرض عضال لا نقوى على مواجهته، وهذا المعنى هو ما أكده
الإمام ابن القيم في روائعه حين قال: "ولعل الله قد سقى أخاك بهذا الذنب
دواءً استخرج به داء قاتلاً هو فيك ولا تشعر، فلله في أهل طاعته ومعصيته
أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، ولا يأمن كَرَّات
القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله".
لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
لوم وتقريع المذنبين حتى ولو كانوا من أصحاب الكبائر، وبيَّن أن أقصى ما
يملكه المجتمع حيال هؤلاء هو إقامة حد الله عز وجل عليهم، وليس للناس من
سبيل عقاب على هؤلاء خلاف ذلك، لا قبله ولا بعده.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا" (رواه البخاري).
أي لا يعيِّرها ولا يوبخها...
فقد نالت عقابها الذي كتبه الله عز وجل
عليها، والسوط الذي ضُرِبَت به إنما كان بيد مقلب القلوب، والقصد هو إقامة
الحد، لا التعيير والتثريب، وليس لسيدها أن يلومها أو يعيرها، وإن فعل فقد
تعدى على حكم الله عز وجل بالإضافة والزيادة.
وذاك دأب وخلق جميع أنبياء الله، ومنهم
يوسف - عليه السلام – الذي رغم ما فعله إخوته معه، ورغم قسوتهم وافترائهم
عليه، ورغم تهيئة الله عز وجل لموقف يستطيع فيه الانتقام منهم أو على
الأقل توبيخهم وتقريعهم، إلا أنه عليه السلام قال لهم: "لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" ( يوسف: 92)، ولاحظ معي تذييل تسامحه معهم بالدعاء لهم بالمغفرة، وتأميلهم في رحمة الله عز وجل.
إن الفتنة لا تؤمن على حي، ولتأكيد هذا
المعنى في نفوس المؤمنين، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في
سورة الإسراء؛ وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به سبحانه وتعالى
وأقربهم إليه وسيلة؛ : "وإن كَادُوا
لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا
غَيْرَهُ وإذًا لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً . ولَوْلا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ
كِدتَّ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً . إذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ
الحَيَاةِ وضِعْفَ المَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا" ( الإسراء: 73-75).
وقال صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ قَلْبٍ إِلا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ".
وكان صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ" (رواه بن ماجة).
ذنب أكبر
كتبه :ا.فتحى عبد الستار
يتفاوت
الناس فيما بينهم، غنى وفقرًا، سعادة وحزنًا، جمالاً وقبحًا، صحة ومرضًا،
ويتفاوتون أيضا من حيث طاعتهم لله عز وجل ومعصيتهم له سبحانه.
وكما لا تجيز الشريعة الإسلامية أن
يعيِّر واحدٌ من الخلق أخاه بنقص اعتراه في المجالات الدنيوية المختلفة،
أو يستطيل عليه بتفوقه في هذه المجالات، كذلك – بل من باب أولى – فإنها
تحرم أن يعيِّر المسلم أخاه بمعصية وقع فيها، ويتفاخر عليه بتقواه لله عز
وجل وطاعته له، فضلاً عن أن يفضحه أو يشهِّر به.
شماتة مرفوضة
إن التعيير بالذنب نوع من إظهار الشماتة بالمسلم، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ" (رواه الترمذي).
والمتأمل في هذا الحديث الشريف يجد
النهي الواضح عن إظهار الشماتة بالمسلم، والترهيب والتحذير لمن يفعل ذلك،
ومن أهم ما يدرَك من الحديث: التخويف من أن الشماتة أو التعيير قد يكونان
سببًا في ابتلاء المعير أو الشامت بالعيب أو النقص الذي عيَّر به أخاه.
إن الله عز وجل قد يعافي أخاك من
المعصية التي وقع فيها، وقد يغفر له تقصيره وذنبه، ويهيئ له سبل التوبة
والعودة والإنابة، ولكنك لا تدري إن ابتلاك الله عز وجل بمثل ما وقع فيه
أخوك...
هل ستعافَى أم لا؟
هل ستتوب أم لا؟
هل سيغفر لك الله ويقبل توبتك أم لا؟.
ومما روي من روائع الإمام ابن القيم
قوله:" إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثمًا وأشد ذنبا من المعصية ذاتها،
وذلك لأنه يحمل في طياته معاني التكبر والغرور بالطاعة لدى صاحبه، ويعبر
عن تزكية النفس وشكرها، ووصفها - ضمنيًّا- بالبراءة من الذنب، والتنزه عن
المعصية".
ويضيف ابن القيم: "ولعل كسر نفس أخيك
بسبب ما وقع فيه من ذنب، وما حدث له من الذلة والخضوع، بسبب ما اقترف من
معصية، وتخلصه من مرض الكِبر والعُجب، ووقوفه بين يدي الله منكس الرأس،
خاشع الطَّرْف، منكسر القلب، لعل هذا أنفع له وخير من صولة طاعتك وزهوك
بها، والمن بها على الله وعلى خَلقه".
ومما أثر من حكم ابن عطاء الله السكندري قوله: "رب معصية أورثت ذُلاً وانكسارًا، خير من طاعة أورثت عزًّا واستكبارًا".
وكلام ابن عطاء الله يتسق مع ما قاله
ابن القيم من أنه "ما أقرب المذنب العاصي من رحمة الله، وما أقرب المغرور
المتكبر من مقت الله!
إن الذنب الذي تَذِلُّ به لله عز وجل،
أحب إليه من طاعة تمُنُّ بها عليه سبحانه، فإنك إن تبيت نائمًا وتصبح
نادمًا، خير من أن تبيت قائمًا وتصبح معجبًا، فإن المعجب لا يصعد له عمل،
وإنك إن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت مُدِل، وأنين المذنبين أحب
إلى الله عز وجل من زَجَل المسَبِّحين المدِلِّين".
أيكون الذنب دواء؟!
ومن رحمة الله بنا أنه قد يجعل في الذنب
نذنبه دواءً لمرض عضال لا نقوى على مواجهته، وهذا المعنى هو ما أكده
الإمام ابن القيم في روائعه حين قال: "ولعل الله قد سقى أخاك بهذا الذنب
دواءً استخرج به داء قاتلاً هو فيك ولا تشعر، فلله في أهل طاعته ومعصيته
أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، ولا يأمن كَرَّات
القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله".
لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
لوم وتقريع المذنبين حتى ولو كانوا من أصحاب الكبائر، وبيَّن أن أقصى ما
يملكه المجتمع حيال هؤلاء هو إقامة حد الله عز وجل عليهم، وليس للناس من
سبيل عقاب على هؤلاء خلاف ذلك، لا قبله ولا بعده.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا" (رواه البخاري).
أي لا يعيِّرها ولا يوبخها...
فقد نالت عقابها الذي كتبه الله عز وجل
عليها، والسوط الذي ضُرِبَت به إنما كان بيد مقلب القلوب، والقصد هو إقامة
الحد، لا التعيير والتثريب، وليس لسيدها أن يلومها أو يعيرها، وإن فعل فقد
تعدى على حكم الله عز وجل بالإضافة والزيادة.
وذاك دأب وخلق جميع أنبياء الله، ومنهم
يوسف - عليه السلام – الذي رغم ما فعله إخوته معه، ورغم قسوتهم وافترائهم
عليه، ورغم تهيئة الله عز وجل لموقف يستطيع فيه الانتقام منهم أو على
الأقل توبيخهم وتقريعهم، إلا أنه عليه السلام قال لهم: "لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" ( يوسف: 92)، ولاحظ معي تذييل تسامحه معهم بالدعاء لهم بالمغفرة، وتأميلهم في رحمة الله عز وجل.
إن الفتنة لا تؤمن على حي، ولتأكيد هذا
المعنى في نفوس المؤمنين، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في
سورة الإسراء؛ وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به سبحانه وتعالى
وأقربهم إليه وسيلة؛ : "وإن كَادُوا
لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا
غَيْرَهُ وإذًا لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً . ولَوْلا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ
كِدتَّ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً . إذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ
الحَيَاةِ وضِعْفَ المَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا" ( الإسراء: 73-75).
وقال صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ قَلْبٍ إِلا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ".
وكان صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ" (رواه بن ماجة).