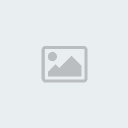
إن (أصول الفقه) هو ذلك العلم الذي يشتمل على المعايير المجردة التي بمقتضاها يقيس المجتهد المشكلات والمسائل الفرعيه
العملية على ضوء القرآن والسنة، لإعطائها الوصف الشرعي المناسب لها من حيث الحكم : بالحلية ، أو الإباحة ، أو التحريم ، أو الكراهة ، أو الوجوب ، أو الندب.
لا يقتصر علم أصول الفقه على معايير فهم نصوص القرآن والسنة مستقلة عن بعضها ـ بما يشتمل عليه من قواعد كلامية ومنطقية تفسر هذه النصوص ـ وإنما يتعدى ذلك إلى شموله معايير فهم الروح العامة للشريعة الإسلاميّة ، التي ترمي إلى تحقيق المصالح ، في إطار من السماحة والتيسير على أفراد المجتمع.
لذلك وجدنا الفقهاء قديما يجتهدون بكل ما يملكون من قدرات لتحقيق المصالح، في ضوء روح التيسير، فيحكمون على بعض الأعراف بالشرعية بالرغم من مخالفتها لصراحة النصوص العامة، لأنها من جهة أخرى موافقة للروح العامة للشريعة.
ومن ناحية أخرى، هناك أمور ومسائل سكتت عنها المصادر فلم يتناولها القرآن ولا السنة تناولا مباشرا، وإنما رسما طريقة عامة في إطارها يجب الاجتهاد والنظر فيها: {والذين استجابوا لربِّهم وأقاموا الصلاةَ وأمرهم شورى بينهم ومِمَّا رزقناهم يُنفِقون} [الشورى:38] .
وإطاعة أمر الله بالشورى في حل هذه الأمور لا يقتصر على جيل بعينه، فالقرآن يخاطب العباد في كل زمان ومكان، إذن فالأمر بالشورى باق ، والعمل به واجب علينا، وذلك يدعونا إلى الاجتهاد.
والاجتهاد له ضروب وأنواع عديدة، لأن التأمل والتفكير هو عملية عقلية فردية، تختلف باختلاف الحاجات والأهداف المتنوعة، ومن صورها اجتهاد الفقيه والمفكر ، الذي هو موضوع بحثنا هذا.
أما الاجتهاد الجماعي بالتشاور، فهو تجميع للاجتهادات الفردية ومضاهاتها بغرض معرفة الرأي أو الفتوى ـ التي هي محل مشترك بين العدد الغالب للاجتهادات الفردية ـ لاتباعها والعمل بها احتراما لأمر الله -سبحانه وتعالى- بالشورى.
وللشورى ضروب وصور عديدة، وهي بجميعها لا تخرج عن التحليل السابق؛ لأن الجماعة ليست عقلا واحدا يفكر، وإنما هي عقول فردية يفكر كل منها ويحلل ، باستقلال عن الآخر.
إن السلف تركوا لنا تراثا ليس فيه ـ بعد القرآن والسنة ـ أثمن من علم أصول الفقه وقواعده الكلية.
والعمل بهذا العلم يقتضي الاعتماد على معاييره بعيداً عن تقليد الفروع الموروثة عن السلف التي تكدست في مكتباتنا ، وجعلتنا نتكاسل عن رؤية واقعنا المعاصر، استسهالاً منا لنقل الفتوى عن غيرنا.
وبذلك قلبنا الأوضاع السليمة ، وصار المناخ العام هو جعل الرجوع إلى الفروع وتقليدها أولى من الرجوع إلى القرآن وفهم نصوصه وروحه على ضوء واقعنا المعاصر.
وصرنا أحزابا متعصبة لمذاهب ، دون أن نفهم أو نعي أن المذهب كان مدرسة أصولية فكرية ، تربي التلاميذ على الاشتغال بالأصول الفكرية، وعلى عدم تهيب مخالفة رأي الأستاذ ، فقد كان تلاميذ الأئمة ـ بالرغم من أنهم يتبعون منهجهم العلمي الأصولي ـ يخالفونهم الرأي في أمور عديدة.
إذن، فالزمان يتغير ، والأحداث لا تنتهي، والعمل المستمر لطاعة أوامر الله -سبحانه وتعالى- يقتضي منا الاجتهاد المستمر باتباع قواعد أصول الفقه.
والاشتغال بهذا العلم لن ينتج عنه تغيير الثوابت بل العكس فهو يحافظ عليها.
إن المتغيرات الاجتهادية ـ أي الفتاوى التي لا حرج في تغييرها باتباع معايير أصول الفقه ـ كثيرة في كتب التراث، والمطلوب : وضع تلك الفتاوى والآراء في نصابها ، بإعطائها قيمة استشارية من جانب العلماء المعاصرين، وعدم التهيب من التعديل فيها ، أو مخالفتها باتباع منهج أصول الفقه، وإلا ّ صارت مثلها مثل أحكام القرآن.
إن الإمام الشافعي قديماً غيَّر من فتاواه التي قال بها في العراق عندما جاء إلى مصر، بالقدر الذي دفع المؤرخين إلى القول بأنَّ له مذهبين: مذهب قديم عراقي، ومذهب جديد مصري.
ونظراً لأن كتب التراث كانت مخطوطات كتبت للتداول بين أيدي المتخصصين آنذاك، ولم تكن بحوزة الجمهور العريض من عامة الناس ومثقفيهم، لذلك لم يهتم مؤلفوها بوضع إشارات توضيحية كافية تبين المصدر المباشر الذي استقى منه الفقيه الحكم ، أو الفتوى التي أصدرها، لأن قارئي هذه الكتب ـ وقتها ـ لم يكونوا بحاجة لمثل هذه الإيضاحات لمعرفة ما هو راجع إلى النصوص ، أو العرف ، أو الاستحسان ، أو المصلحة من أحكام.
أما اليوم، وقد صارت هذه الكتب ـ بفضل الطباعة ـ بين أيدي العامة من الناس، فقد أدى ذلك إلى إعراضهم عن علماء العصر، اعتقاداً منهم بعدم الحاجة لهؤلاء العلماء ، طالما كانت تلك الكتب ـ حسبما يعتقدون ـ تحوي جميع أبعاد المسائل المطروحة فيها، ويعتبرون أن جميع ما بها هو من الثوابت قياسا على الأجزاء الخاصة بالعبادات.
ولهذا السبب ؛ يظهر من بين العامة من يدعي العلم، وهو في واقع الأمر مجرد تماما من الملكات الاجتهادية ، ولا يعدو أن يكون مجرد حافظ مردد لأقوال غيره، دون تأمل أو تمحيص ، فيما يمكن تغييره وتعديله ، وما لا يمكن. ويتجمع الناس حول هذا الشخص معتقدين أن جميع ما يردده له قيمة القرآن المنزل من السماء.
وللأسف، ليس هناك إلى الآن مجهودات كافية من علماء عصرنا لوضع الإشارات التوضيحية في كتب الفقه المنتشرة بين أيدي الناس ـ بسبب الطباعة وتقدم التكنولوجيا ـ حتى يكونوا على علم بالثوابت الراجعة إلى : القرآن والسنة ، والمتغيرات الراجعة إلى : العرف والمصلحة والاستحسان ، وغير ذلك من الأدلة الشرعية.
إن العمل بقواعد أصول الفقه ـ فيما هو جديد وكذلك فيما هو موروث ـ هو الأصل في الشريعة. والفقهاء القدماء هم الذين نهوا عن التقليد وقالوا إنه يؤدي إلى تعطيل الشريعة.
ومن الثابت أن المعايير الأصولية كان يعمل بها جميع الفقهاء القدماء، وإنما تميز الإمام الشافعي بالفضل الكبير في الكشف عن هذه المعايير وتنظيرها.
إن الإخلاص الحقيقي للسلف ، هو بالعمل على طريقتهم الفكرية ، واتباع منهجهم الأصولي ـ دون تقليدهم في الفروع والفتاوى ـ لأننا بذلك نكون امتدادا حقيقياً لهم، بل وكأننا (أحييناهم).
أما ترديد أقوالهم وفتاويهم، دون اجتهاد وتبصر، فمعناه أننا نحكم عليهم بضيق الأفق ، ونحكم على الشريعة ـ كلها ـ بأنها ليست منبعا مستمرا متدفقا للحلول والتقديرات في كل زمان ومكان.
إن المسؤول عن العمل بأصول الفقه بفكره الشخصي هو العالم بمعايير هذا العلم.
أما العمل بأصول الفقه ومعاييره من حيث الموقع فهو عام ، ويجب أن يكون في شتى المجالات في المجتمع الإسلامي ، الذي يبغي تطبيق الشريعة تطبيقا معياريا عصريا صحيحا.
والعمل بهذه المعايير ـ في المواقع المختلفة ـ ليس معناه أن يكون جميع المسؤولين على دراية بها، وإنما قد يرجعون في هذا الشأن إلى أصحاب هذه الدراية ، أو يكون لهم مستشارون متخصصون في ذلك.
إذن فيجب أن يتوافر عدد كبير من علماء الفقه وأصوله في المجتمع الإسلامي.
إذا أراد طالب العلم الفقه فهل له الاستغناء عن أصول الفقه ؟
الجواب: الحمد لله ؛ سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ السؤال السابق فأجاب فضيلته بقوله:
إذا أراد طالب العلم أن يكون عالماً في الفقه فلا بد أن يجمع بين الفقه وأصول الفقه ليكون متبحراً متخصصاً فيه ، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول ، ولكن لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيهاً بدون علم الفقه أي أنه لا يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه , ولهذا اختلف علماء الأصول هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه حتى يبني الفقه عليها , أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه , حيث إن الإنسان يحتاج إليه في عمله , في عبادته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه , والثاني هو الأولى وهو المتبع غالباً .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، «كتاب العلم»، الصفحة (190 )


